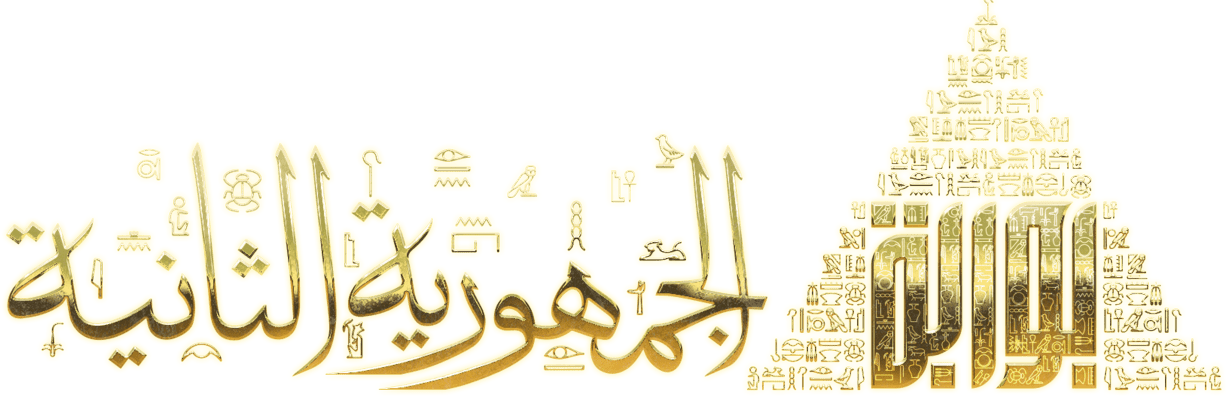“الاتفاق” الصومالي الإثيوبي.. أردوغان “الوظيفي” يتحرك في فناء مصر الخلفي!

إعداد: أحمد التلاوي
في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصومال وإثيوبيا “اتفقا على إعلان مشترك لحل خلافاتهما”، وذلك في أعقاب محادثات أجراها في العاصمة التركية مع كل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وبقطع النظر عن أن الإعلان التركي والمواقف الرسمية الصومالية والإثيوبية لا تحمل شيئًا محددًا؛ إلا أنه تبقى لهذا الحدث دلالاته الكبيرة، على الكثير من الأمور المثارة حاليًا في المنطقة، وبصفة خاصة، مصر ومصالح أمنها القومي في فتائها الجيوسياسي الجنوبي.
وفي الحقيقة إن عدم حَمْل الإعلان التركي لترتيبات محددة فيما يخص نقطة الخلاف الأساسية بين الصومال وإثيوبيا، والمتعلقة باتفاق أديس أبابا مع “جمهورية أرض الصومال” الانفصالية، بشأن حصول إثيوبيا – التي هي دولة حبيسة – على موطئ قدم في أحد موانئها على خليج عدن والمدخل الجنوبي البحر الأحمر، هو في حد ذاته أكثر أهمية مما لو كان قد حَمَل – الإعلان التركي – في طياته خطوات تنفيذية أو نتائج آنية واضحة.
إطلالة سريعة على ما تم في أنقرة
ما أعلن عنه أردوغان يأتي ضمن ما يُعرَف “عملية أنقرة” التي أطلقتها الحكومة التركية قبل حوالي ثمانية أشهر بين إثيوبيا والصومال، بعد الأزمة التي ثارت بين مقديشو وبين أديس أبابا إثر توقيع الأخيرة في يناير الماضي اتفاقها المثير للجدل مع “صوماليلاند” أو “أرض الصومال” تقتطع بمقتضاه إثيوبيا 20 كيلومترًا من سواحل “صوماليلاند”، على ساحل البحر الأحمر، لإقامة ميناء عليها.
وفي تفاصيل “نتائج” تحرُّك أردوغان الأخير، أن إثيوبيا والصومال “قرَّرا وبتسهيلات من تركيا بَدء المفاوضات الفنية في موعد أقصاه نهاية فبراير 2025ـ والتوصُّل إلى نتيجة خلال 4 أشهر”.
ثم مضى الإعلان التركي في الحديث الفضفاض، عندما قال: “إن الطرفَيْن أقرَّا بالفوائد المحتمَلة التي يمكن تحقيقها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال”.
ولم يوضِّح البيان كيفية حدوث ذلك فيما يتعلق بالشق الخاص بالصومال؛ حيث إن “جمهورية أرض الصومال” كيان انفصالي بالفعل، ولم يعترف به أحد سوى إثيوبيا، بينما لا تملك الحكومة الصومالية المركزية في مقديشو، صاحبة السيادة الاسمية فحسب على الأرض، أية أداة يمكنها بها فرض كلمتها، أو ممارسة صلاحياتها فعليًّا هناك، ما لم تندلع حربًا لإخضاع الإقليم، وقدرات الحكومة الصومالية المركزية لا تمكِّنها من ذلك.
أردوغان وتحركات في الفناء الخلفي المصري
ليس هذا التحرك الأول بالنسبة لتركيا في هذه المناطق، وينسجم مع تحركات أخرى عديدة لها في إفريقيا، لخدمة مشروع توسُّع تنظيم الإخوان الإرهابي في القارة السمراء، والذي بدأ منذ عقود، وأخذ مساراته التنفيذية بصورة أكثر فاعلية في عهد المرشد العام السابع للجماعة، محمد مهدي عاكف.
وكما نعلم، فإن هذا التنظيم الإرهابي ذو طابع وظيفي، أي يعمل ويتم توجيهه في خدمة سياسات المستعمِر البريطاني القديم، ووريثه، الولايات المتحدة.
وبالتركيز على الصومال والتحركات التركية هناك، والتي تكشف بعضًا من جوانب المشروع التوسُّعي التركي في العالم العربي، بما في ذلك حزام الأمن القومي المصري والعربي الجنوبي، نشير إلى بعض الأمور التي جرت في العام الحالي.
في فبراير الماضي، وقعت أنقرة ومقديشو اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تم بموجبها ترتيب حضور تركي واسع النطاق في الصومال.
ففي منتصف يوليو، أعلنت وزارة الطاقة التركية أن أنقرة سوف ترسل سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصومالية، وبالفعل، في خريف العام الجاري، تم إرسال سفينة تنقيب تركية تحمل اسم “كمال عوريج” إلى هناك.
ثم، وفي 27 يوليو، وافق البرلمان التركي على نشر عناصر من القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامَيْن، بموجب الاتفاقية السابقة المشار إليها.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن القوة المسلحة التركية سوف تنتشر في مناطق الولاية البحرية للصومال، تحت ستار “مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الدفاع البحري الصومالي”.
رافق ذلك تحرك دبلوماسي مكثَّف على مستوى القمة من جانب الصومال؛ حيث قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بزيارتَيْ دولة لتركيا، في شهرَيْ مارس ويونيو الماضيَيْن.
وذكرنا أن هذه التحركات لا تنفصل عن تحركات تركية أخرى في محور الساحل والصحراء، وتموِّله قطر، وتعمل فيه تركيا بمختلف أدوات الدولة، من الأداة الإغاثية من خلال منظمات حكومية تركية مثل “تيكا” التي تقوم بحفر الآبار وإقامة مستشفيات ومدارس صغيرة، وصولاً إلى الدفاع والدبلوماسية.
ففي 18 يوليو الماضي – على سبيل المثال – قام وزير الخارجية، ومدير الاستخبارات التركية السابق، هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار جولر، والمدير الحالي لجهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالِن، بزيارة إلى النيجر، لتنسيق بعض الأمور العسكرية والأمنية هناك.
يرتبط بذلك، الصراع الدولي الكبير في هذه المنطقة، والذي تنخرط فيه روسيا منذ سنوات ضد النفوذ الفرنسي، ونفوذ المحور الأنجلو أمريكي.
وبالفعل نجحت روسيا التي لا تزال تحتفظ بقوات تابعة لما يُعرَف بـ”الفيلق الإفريقي” أو “فيلق إفريقيا” وريث شركة “فاجنر” بعد تمرد مؤسسها يفجيني بريجوجين على الدولة الروسية في العام الماضي، في بعض الدول هناك، مثل أفريقيا الوسطى والنيجر وبوركينا فاسو، في الإطاحة بعدد من الأنظمة الموالية لفرنسا، كما حصل في النيجر نفسها، في يوليو 2023م.
يتفق ذلك مع مفهوم الدور الوظيفي الذي يلعبه التنظيم الدولي للإخوان، والحكومات المنبثقة عنه أو ترعاه بموجب تنسيقية أمريكية وبريطانية، شاهدناها منذ مرحلة ما قبل ما يُعرَف بثورات الربيع العربي، وحتى الآن، وتتضمن مراكز بحوث صهيونية، مثل معهد “حاييم – سابان” الذي كان له فرع في الدوحة، تم إغلاقه مع أفرع أخرى لمراكز مماثلة بعد المصالحة مع دول الخليج الأربع ومصر في العام 2021م.
لماذا قَبِلَت إثيوبيا العرض التركي؟!
بالرغم مما عُرِفَ عنه بتصلُّب المواقف؛ قَبِل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا الاتفاق “الشاحب” لو صحَّ التعبير، لعدد من الأسباب، من بينها التغيير السياسي الذي حدث في “جمهورية أرض الصومال” أو “صوماليلاند”.
ففي نوفمبر الماضي، جرت انتخابات رئاسية في الإقليم الانفصالي، فاز بها السياسي الراديكالي المعارِض عبد الرحمن محمد عبد الله (الشهير بعبد الرحمن عرو) بانتخابات رئاسة الإقليم، على حساب سلفه السابق موسى نيهي عبدي.
وبالتالي؛ نشأ تخوُّف لدى الإثيوبيين من تراجع الرئيس الجديد عن الاتفاقية السابقة التي منحت بها “صوماليلاند” إثيوبيا شريط العشرين كيلومترًا الذي يعيدها إلى المياه الدولية مجددًا، بعد أنْ أصبحت حبيسة بعد انفصال إريتريا عنها في العام 1993م.
وهو ما دفع آبي أحمد بحسب مراقبين، إلى التوجُّه إلى الصومال المركزي، ربما للحصول على موافقته على ما تم الاتفاق عليه مع “صوماليلاند”.
وبالنظر إلى طبيعة عرو؛ فإن هذا التحرك فاشل؛ لأن عرو أكثر تشددًا من عبدي، وإذا ما كانت إثيوبيا قد تخوفت من تراجع “صوماليلاند” عن فكرة اقتطاع جزء من أراضيها لصالح سيادة دولة أخرى؛ فإنه بالتأكيد سوف يرفض نفس المسعى لو جاء من مقديشو التي هي في الأصل تنفي وجوده، وبالتالي لا محل ولا اعتبار لها عند الإقليم الانفصالي؛ لأن هذا يعني نهاية مشروع الدولة هناك أصلاً.
أما الصومال، فربما وجد شيخ محمود في الاتفاق المبدئي هذا، فرصة لاستعادة سيادة مقديشو المفقودة على “صوماليلاند”، إلا أن التعميم الكبير الذي جاء في الإعلان التركي وتصريحات أردوغان لا يفيد بأي شيء في هذا الاتجاه، ولا يوجد أية آليات تنفيذية ممكنة في الوقت الحالي، وبخاصة بعد فوز عرو بالانتخابات الرئاسية في الإقليم الصومالي.
مصر واعتبارات أمن قومي عديدة
بجانب محاولة مصر استعادة نفوذها القديم الطاغي في القارة السمراء منذ سنوات الاستقلال في الخمسينيات والستينيات، فإنه استجابة لأكثر من تحدٍّ لمصالح الأمن القومي المصرية، بدأت مصر في العمل على استعادة وجودها في إفريقيا، من خلال الأداة التي أصبح العالم الآن لا يفهم سواها، وهي المصالح الاقتصادية والتنمية.
ومن بين هذه التحديات، من بينها الإرهاب، بما يتضمنه من تمركزات جماعات دينية، منها تنظيم الإخوان وتنظيمات أخرى تابعة تنظيميًّا لـ”القاعدة” وتنظيم الدولة “داعش”، بالإضافة إلى أعمال القرصنة التي تتم في المياه الإقليمية والدولية قُبَالة القرن الإفريقي، وتمثل مساسًا بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري.
ثم كانت هجمات جماعة “أنصار الله” الحوثي اليمنية خلال حرب غزة الحالية، على السفن المارة في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، والذي أدَّى إلى فقدان مصر لمليارَيْ دولار من عائدات قناة السويس في أقل من عام.
بالإضافة بطبيعة الحال، بموضوع “سد النهضة”؛ حيث بدأت مصر قبل سنوات في عملية تطويق لإثيوبيا من خلال سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية والأمنية والاقتصادية مع دول الجوار الإثيوبي، بما في ذلك الصومال وأوغندا وإريتريا.
ونذكِّر هنا بالنشاط الكبير الذي بدأته الخارجية المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، بما فيها المخابرات العامة والقوات المسلحة، وكانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا في العاشر من أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس الصومالي شيخ محمود، وكانت العناوين العامة لكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة الثلاثية المصرية الإريترية الصومالية وقتها، بالإضافة إلى بيانات الخارجية المصرية، تتناول هذه القضايا كلها، وبخاصة الإرهاب وأمن البحر الأحمر.
كما أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال، وبعض الوحدات العسكرية، للعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال المعروفة باسم (أتميس).
والحقيقة أنه من غير المُتَوقَّع أنْ يتجاوز الرئيس الصومالي الترتيبات القائمة مع مصر، على هشاشتها بدورها في ظل عالم قَلِق غير مضمون فيه أي شيء.
لكن شيخ محمود الضعيف للغاية لأسباب كثيرة، منها ضعف قدرات الدولة المركزية في الصومال، وعدم قدرتها على بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني حتى في المناطق التي لا تزال اسميًّا تابعة لها، بسبب نشاط تنظيمات مسلحة مثل “شباب المجاهدين” الموالي لـ”القاعدة”، يجد نفسه يتحرك في كل الاتجاهات لضمان بعض مصالح بلاده، والحصول على أي مكسب لها، بما يضمن على الأقل استمراره هو في منصبه.
ولذلك نجده يتحرك مع قوى أكبر منه وأكثر استقرارًا، وتملك ما تمنحه له، وسيَّان في ذلك مصر أو تركيا، ولكنه لا يضع في أولوياته – بشكل منطقي على الأقل – مصالح مصر أو مصالح تركيا على حساب مصالحه هو، ومصالح كيانه الهَشِّ في الأصل.
وفي النهاية، وبقطع النظر عن الطابع المراسيمي الواضح الذي يحمله التحرك التركي الأخير، وعن المصالح التي تحرك الصومال في هذا الاتجاه؛ فإنه قَصَد محاولة قطع الطريق على التحركات المصرية هناك، بكل ما تهتم به هذه التحركات من قضايا مهمة للأمن القومي المصري.