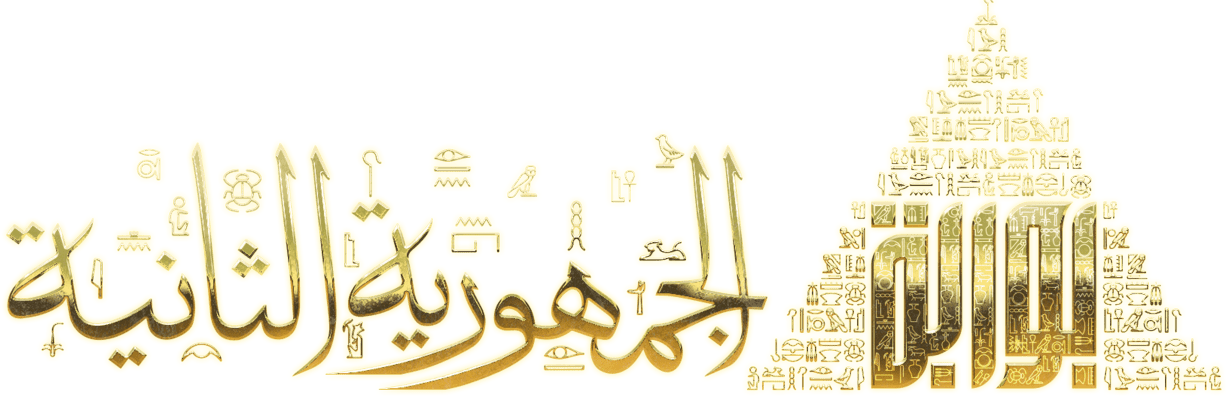منذ أن عرف الإنسان الكلمة كانت الحقيقة هدفا مقدسا والإعلام وسيلتها النبيلة. لكن شيئا فشيئا ، تبدّل المشهد حتى صار الإعلام أحيانا طرفا في الصراع لا ناقلا له وصار المتلقي يتساءل كل يوم: أين الحقيقة وسط هذا الضجيج الهائل؟
فالعالم يعيش اليوم أزمة ثقة عميقة بين ما يُقال وما يُرى بين ما يُبث على الشاشات وما يُلمس في الشوارع. لم تعد الصورة دليلا على الصدق ولا الكلمة ضمانا للحق فكل طرف يملك منصته وسرده ومصادره بينما الحقيقة في كثير من الأحيان تُدفن تحت ركام الروايات المتضادة.
في الماضي كان الإعلام يُنظر إليه باعتباره “مرآة المجتمع” أما اليوم فقد صار ـ في أحيان كثيرة ـ “مسرح المجتمع”، يصنع المشهد كما يشاء ويعيد ترتيب الأحداث وفقا لما يريد. وفي زمن الصورة الرقمية والذكاء الاصطناعي لم تعد المعلومة تُقاس بمصدرها بقدر ما تقاس بسرعة انتشارها وتأثيرها. فكل من يملك كاميرا وهاتفا صار قادرا على أن يصنع روايته الخاصة للعالم وأن يوجّه الرأي العام في الاتجاه الذي يختاره.
لقد تجاوزت الأزمة حدود الخبر إلى عمق الفكرة. لم يعد السؤال: هل ما نسمعه صحيح؟ بل أصبح: من يريد لنا أن نسمع هذا؟ وهنا تتجلى المعضلة الكبرى: لم تعد المعركة حول المعلومة بل حول النية التي تُبث من خلالها المعلومة. فمن يملك الميكروفون لا يكتفي بالحديث بل يحدد الإيقاع والنغمة بل وحتى ما يُسمح للناس أن يسمعوه.
إن أخطر ما فعله الإعلام المعاصر أنه جعل الحقيقة نسبية. أصبح لكل فريق حقيقته الخاصة ولكل دولة روايتها الرسمية ولكل جماعة منصتها التي تخلق بها واقعًا موازيا وهكذا ضاعت الحقيقة بين زوايا المونتاج ومصالح الممولين وذكاء المخرجين الذين يجيدون صناعة المشهد أكثر من نقل الواقع.
ولم يعد الإعلام الحديث مجرد ناقل للمعلومة بل تحول إلى أداة تشكيل للعقل الجمعي. في كثير من الأحيان.تُصاغ الأخبار بطريقة انتقائية تبرز جزءا وتغفل آخر تُضخم تفصيلة وتهمل أخرى حتى تُدفع الجماهير نحو قناعة محددة. ومع تكرار الصورة، وتعدد المنابر وتوحّد الرسالة يتحول التوجيه الإعلامي إلى وعي جمعي لا يشعر صاحبه أنه موجّه بل يظن أنه يفكر بحرية!
ولأن الإنسان ابن ما يراه ويسمعه، فقد صار الإعلام اليوم شريكًا رئيسيًا في صناعة الإدراك العام، لا مجرد وسيلة لعرض الوقائع. في لحظة ما، قد يتحول مذيع أو مؤثر إلى زعيم رأي وقد يصبح منشور على منصة اجتماعية أكثر تأثيرًا من نشرة أخبار رسمية. هذه السيولة في صناعة الوعي جعلت الحقيقة نفسها في مأزق لأن كل من يملك قدرة على التأثير يملك القدرة على التزييف أيضا.
ورغم هذا الضجيج ما زال هناك إعلام حقيقي يحترم القارئ ويقدّس الكلمة ويوازن بين نقل الحدث وتحليل أبعاده. هذا الإعلام هو الذي يميز بين السبق الصحفي وبين السبق في التضليل بين الجرأة في قول الحق وبين الجموح نحو الإثارة. إنه إعلام يعرف أن مهمته ليست أن يُرضي الجماهير بل أن يُنير وعيها.
في المقابل هناك إعلام يعيش على اللهاث وراء الترند يخلط بين الترفيه والتوجيه ويقيس النجاح بعدد الإعجابات والمشاهدات لا بعمق الفهم والوعي. هذا النوع من الإعلام وإن بدا صاخبا ولامعا إلا أنه يترك وراءه فراغا معرفيا وضبابا في الرؤية. لأن المعلومة إذا انفصلت عن ضميرها تصبح مجرد أداة للعبث بالعقول.
لقد كشفت الأزمات الكبرى – من الحروب إلى الجوائح – عن حجم الفجوة بين الإعلام والواقع. رأينا كيف يُصنع البطل من لا شيء وكيف يُشيطن الشرفاء وكيف تتحول المنصات إلى ميادين للاغتيال المعنوي. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن الإعلام الجاد في المقابل كان له الدور الأكبر في كشف الفساد ومساندة القضايا العادلة وتنوير العقول. فالمعادلة لا تُختزل في الأبيض والأسود بل في مدى صدق النية ونقاء الغاية وعمق الرسالة.
إن ما نحتاجه اليوم ليس إعلاما جديدا فحسب بل ضميرا إعلاميا جديدا . ضميرا يدرك أن الكلمة أمانة وأن نقل الخبر مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية. ضميرا يفرّق بين النقد والتشويه وبين الحقيقة والمصلحة وبين التنوير والتحريض. لأن الإعلام حين يفقد بوصلته، لا يضل وحده بل يُضلّ معه أمة كاملة.
ولعلّ التحدي الأكبر الآن هو استعادة التوازن بين الحرية والمسؤولية. فالإعلام الحر هو الذي يراقب ويكشف ويحلل دون أن يتحول إلى أداة هدم. وهو الذي يُمارس النقد دون أن يسقط في فخ الكراهية أو الاستقطاب. وهو الذي يضع الوطن في القلب دون أن يضع المصلحة الشخصية على القمة.
في النهاية تبقى الحقيقة ـ رغم كل ما يُثار حولها ـ قادرة على الصمود. قد تُحاصر بالكذب وقد تُشوّه بالصور لكنها لا تموت. فهناك دوما من يبحث عنها بإخلاص وهناك من يملك الوعي ليفرّق بين الزيف والصدق. إن الإعلام النزيه لا يُقاس بعدد متابعيه، بل بعدد الذين أيقظهم من غفلتهم.
ولعل أجمل ما يمكن أن يُقال في هذا السياق أن الحقيقة لا تحتاج إلى من يصنعها بل إلى من يُنير طريقها. ومتى عاد الإعلام إلى جوهر رسالته الأولى — رسالة الصدق والمسؤولية — سيعود له مجده الحقيقي وتعود الثقة إلى مكانها الطبيعي بين الكلمة والضمير بين الإعلام والواقع.