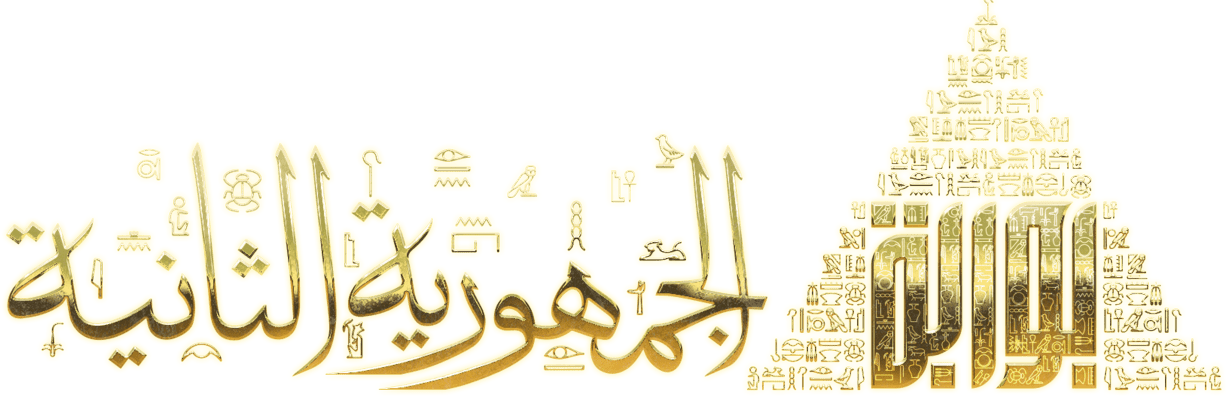لم يكن افتتاح المتحف المصري الكبير مجرد حدث ثقافي أو احتفال أثري، بل كان لحظة نادرة تلتقي فيها الأزمنة الثلاثة: الماضي الذي صنع المجد، والحاضر الذي يحميه، والمستقبل الذي يستكمله على بصيرة. كانت القاهرة في تلك الليلة تُشبه نفسها يوم ميلاد الحضارة حين خطّ الفراعنة أول أبجدية للنور على جدران المعابد وكأن الزمان دار دورته ليقف احتراما أمام أمّة عرفت كيف تكتب تاريخها بالحجر وتوقّعه بالذهب.
المتحف المصري الكبير ليس صرحا من حجارة بل وثيقة هوية وبيان ولادة جديدة لمصر الحديثة، التي تُعيد صياغة نفسها بثقة وهدوء، لتقدّم للعالم نسخة أخرى من قوتها الناعمة ، أكثر عراقة وأعمق وعيًا. فبينما تتسابق الدول لإنتاج التكنولوجيا والرفاهية تقدّم مصر للعالم شيئًا لا يُشترى ولا يُقلّد: الخلود.
منذ اللحظة الأولى التي تحوّل فيها الحلم إلى مشروع، كانت الرؤية أبعد من مجرد بناء متحف، بل كانت استعادة لحق مصر في أن تكون “ذاكرة العالم”، المكان الذي وُلدت فيه الحضارة، والروح التي لم تنطفئ رغم قرونٍ من الغزوات والتحولات. أراد المصري أن يقول لكل الأمم: لسنا أبناء التاريخ فحسب، نحن صُنّاعه وحُرّاسه، والذين يُعيدونه للحياة كلما حاول العالم نسيانه.
إن ما فعله المصريون في المتحف المصري الكبير يُشبه معجزة في صمت. آلاف العمال والمهندسين والخبراء المصريين الذين حملوا الآثار بعيونهم قبل أيديهم ونقلوا المومياوات كأنهم يشيّعون ملوكا من زمن الخلود إلى زمن الحداثة دون أن تسقط دمعة تراب من وجه التاريخ. تلك الدقة التي تُشبه العبادة وذلك الإيمان الذي يسكن كل حجر هما ما يجعل هذا الافتتاح ليس مجرد عمل هندسي بل فعل وطني خالص ، يترجم روح مصر حين تعمل وحين تحلم وحين تكتب للعالم رسائلها الخالدة بلغة الجمال.
اليوم حين تقف أمام تمثال رمسيس الثاني وتحدّق في عينيه المعلقتين في الزمان تدرك أن مصر لم تبن متحفل لتعرض آثارها، بل لتعرض **جوهرها**. هذا المتحف لا يضمّ تماثيل فحسب بل يضمّ فكرة مصر نفسها: أن تبقى مهما تغيّر العالم ، وأن تُعلّم أبناءها كيف يُصنع الخلود بالعمل والإيمان لا بالكلام والشعارات.
ولأن مصر لا تعرف أنصاف الأحلام فقد أرادت لهذا المشروع أن يكون على مستوى اسمها وتاريخها فجاء المتحف المصري الكبير أكبر صرح أثري في العالم بأحدث تقنيات العرض والحفظ والتوثيق وكأنه لقاء بين التكنولوجيا الحديثة وحكمة الفراعنة القديمة. في كل ركن من أركانه رسالة تقول: نحن لا نحفظ الماضي فقط بل نمنحه حياة جديدة.
الذين شاهدوا الافتتاح لم يروا فقط عرضا للأثار بل رأوا مشهدا رمزيا يُجسد فلسفة الدولة المصرية في عهدها الجديد: البناء لا الصراع الإحياء لا البكاء على الأطلال والتقدم بثقة لا بالصخب. فكما أن المتحف أعاد إلى العالم وجه مصر الحقيقي أعاد إلى المصريين إيمانهم بأن المستحيل مجرد كلمة.
المتحف المصري الكبير هو أيضا مشروع سياسي بمعناه الحضاري لأنه يعلن بوضوح أن القوة لا تكون فقط في الجيوش والسلاح بل في الثقافة التي تبني الوعي وفي التاريخ الذي يمنحك الشرعية الأخلاقية لقيادة المنطقة. فبينما تُقيم بعض الدول متاحفها لتستعير تاريخا ليس لها تبني مصر متحفًا لتُعيد عرض تاريخها الأصلي كمن يضع مرآة أمام العالم ليقول: انظر.. من هنا بدأ كل شيء.
ولعلّ أعظم ما في هذا الإنجاز أنه جاء في زمن كثرت فيه الفتن وتبدّلت فيه الموازين فإذا بمصر تردّ على الفوضى بصوت الجمال ، وتقول للعالم من قلب المتحف: ها نحن نصنع مستقبلًا يليق بماضينا. إنها فلسفة مصر التي تعود دومًا من قلب العاصفة، أكثر ثباتا وإشراقا لأنها ببساطة لا تعرف الانكسار.
في هذا الافتتاح العظيم لم يكن الاحتفال بالحجر بل بالإنسان المصري نفسه ، الذي لم يفقد قدرته على البناء والإبهار. كل مصري شارك في هذا المشروع من العامل البسيط إلى العالم الكبير وضع بصمته على حجر من أحجار التاريخ. وحين ارتفعت الإضاءة الذهبية في سماء الجيزة لم يكن الضوء يلامس واجهات المتحف فقط بل كان يُضيء وجه مصر كله.
ربما لم يكن المتحف المصري الكبير مجرد افتتاح لمكان بل إعلان عن عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية في وجدان الإنسانية. فمن هنا خرجت الحضارة ومن هنا يتجدد وعد الخلود. واليوم حين يزور العالم هذا الصرح لن يرى فقط آثارًا عظيمة بل سيرى أمة استيقظت لتُذكّر الجميع أن الحلم ممكن وأن الهوية لا تموت وأن التاريخ يمكن أن يُعاد كتابته حين تكون مصر القلم.
شكرا لكل من حلم وبنى وصبر وحمل على كتفيه هذا الصرح العظيم حتى صار واقعًا يبهر العيون. وشكرا لمصر التي لم تتخل يوما عن دورها ولم تفقد إيمانها بأن الجمال شكل من أشكال المقاومة وأن الحضارة الحقيقية لا تُورّث،
بل تُصنع كل يوم من جديد.
هدية مصر للعالم لم تكن متحفا من حجر بل توقيعا من ذهب على صفحة الخلود تذكيرا بأن الزمن يمر لكن مصر تبقى.. لأن في جوهرها سرّا لا يعرفه إلا من آمن بأن النيل لا يجري إلا ليقول:
أنا شاهد على أمة لا تموت.