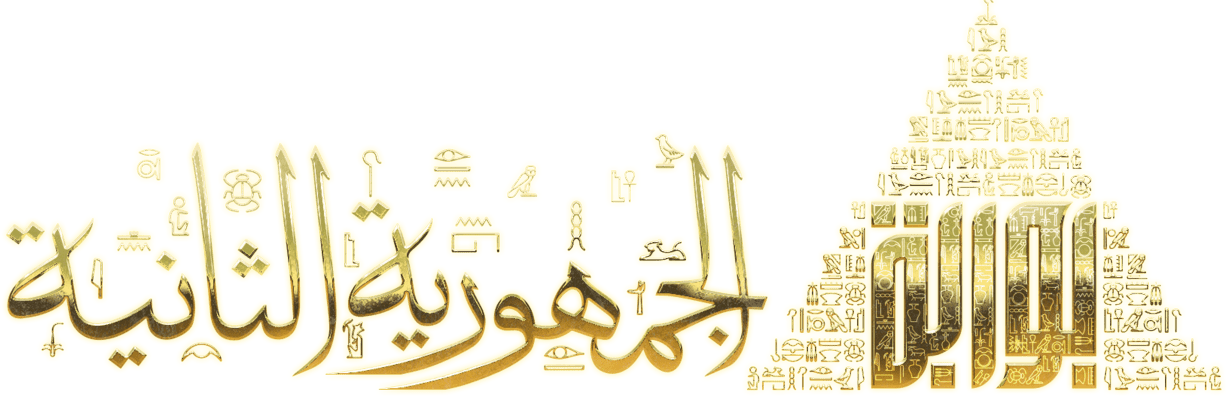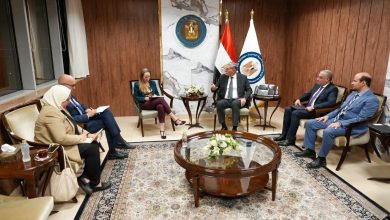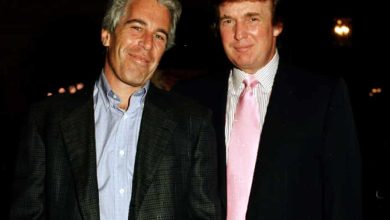استحداث خدمات لأول مرة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الصحي خلال عيد القيامة وشم النسيم

متابعة: بسنت عماد
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بمحافظات التأمين الصحي الشامل، خلال فترة الاحتفالات.
رفع درجة الاستعداد
وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ 309 منشأة صحية تابعة للهيئة ما بين مستشفيات عامة وتخصصية أو وحدات ومراكز لطب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان).
أقسام الاستقبال والطوارئ
وتابع البيان، تم تقليص الإجازات وتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، والتأكد من توافر كافة الأمصال والطعوم، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته لمواجهة أي حالات طوارئ، فضلًا عن تفعيل مراكز السموم المجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل بمحافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء للتعامل الفوري مع أية حالات تسمم غذائي محتملة خلال احتفالات شم النسيم، مع تعيين مشرف فني للاشراف اللحظي على وحدات السموم مركزيًا بالمقر الرئيسي للهيئة.
تشكيل غرفة طوارئ مركزية
وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.