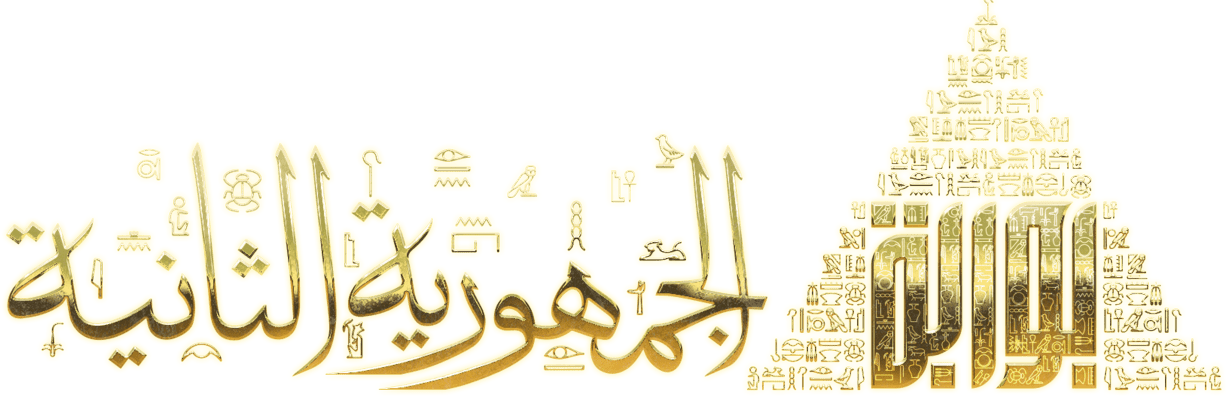في فصول الاقتصاد كما في فصول السنة ثمة صيف لا يرحم، يحرق الهش، ويختبر الصلب، ويكشف المعدن الحقيقي تحت ضوء الواقع، لا وهج الأماني. ومصر هذا العام تقف عند مفترق طرق بالغ التعقيد وسط حرارة سياسية إقليمية وتقلبات اقتصادية عالمية وظلال اجتماعية لا تخطئها العين. إنه “الصيف الساخن”، حيث تُختبر الفاتورة المدفوعة على مدار سنوات وتُقاس الإرادة التي تلوّنت بالتجربة لا بالشعارات.
بعيدا عن التنظير علينا أن نكون صريحين: المواطن المصري يشعر بالضغط. الأسعار تقفز، الجنيه يتراجع، والقدرة الشرائية تتآكل. والأسواق، بطبيعتها، لا تنتظر الشرح، بل تحكمها لغة بسيطة: ما الذي تغير في الجيب؟ وما الذي بقي على الرف؟ لكن خلف هذه المعادلة اليومية التي تفرضها فاتورة الإصلاح الاقتصادي ثمة رواية أكبر تحكي عن دولة اختارت طريقا صعبا ، لكنها لم ترتد عباءة الضحية ولم ترفع الراية البيضاء.
خلال السنوات الماضية كانت هناك ثلاث جبهات مفتوحة في وجه الاقتصاد المصري: صدمة خارجية جاءت من تعاقب الأزمات الدولية من كورونا إلى الحرب في أوكرانيا وصولا إلى تداعيات الحرب في غزة وارتباك الأسواق العالمية؛ أزمة داخلية تتمثل في ارتفاع الاستهلاك الضغط على العملة، وتضخم النفقات الاجتماعية؛ ثم معركة الإصلاح الهيكلي التي دخلتها الدولة برؤية طويلة المدى، وشراكات مع مؤسسات دولية ، وسط مقاومة شرسة من شبكات المصالح القديمة.
وفي قلب هذه المعارك ، تحاول الدولة أن تحافظ على معادلة شديدة الحساسية: كيف تُنقذ الاقتصاد دون أن تضحّي بالاستقرار الاجتماعي؟ كيف تُعوّم العملة دون أن تُغرق الفقراء؟ وكيف تُطمئن المستثمر دون أن تُخيف المواطن؟ ليست مهمة سهلة، خصوصا في ظل ارتفاع الفاتورة التمويلية ، وانكماش تدفق الدولار ، وتشكيك إعلامي خارجي يريد لمصر أن تبدو في كل لحظة وكأنها على حافة الانهيار.
لكن الحقيقة أن ما يحدث رغم قسوته ليس عبثيا ولا بلا ملامح. ففي العمق هناك إرادة سياسية واقتصادية تسير في اتجاه واضح: تحرير الاقتصاد من قبضات البيروقراطية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إعادة صياغة دور الدولة من منافس إلى منظم وتنويع مصادر الدخل، من قناة السويس إلى الطاقة والسياحة والصناعة. وهذه الخطوات التي قد تبدو ثقيلة ، هي ذاتها التي حوّلت دولا أخرى من اقتصادات ريعية إلى كيانات قادرة على الصمود والتوسع.
خُذ على سبيل المثال ما يجري في ملف الطاقة: في عزّ الأزمة وسّعت مصر قدرتها على استيراد وتغييز الغاز واستثمرت في البنية التحتية ، لتضمن الاستقرار في الشهور الأشد استهلاكا. وحين عجزت أوروبا عن تأمين إمداداتها، كانت مصر توقع اتفاقيات مع الأردن وألمانيا ، وتدير ملف الطاقة بمنطق السيادة لا الارتباك. وفي السياحة زادت التدفقات رغم كل التحديات وتمّت إعادة رسم خريطة المنتج السياحي لتشمل العواصم الجديدة والقديمة.
ورغم ذلك.لا تنكر الدولة نفسها أنها أمام تحد كبير. ومن الذكاء أنها لم تكتفِ بالتقارير المطمئنة، بل بادرت بإجراءات تصحيحية: من طرح شركات كبرى في البورصة، إلى تحريك سعر الفائدة بما يناسب السوق، إلى التفاوض المرن مع صندوق النقد ، إلى العمل على جذب استثمارات حقيقية وليست مجرد تدفقات ساخنة.
الأهم أن هناك فهما متزايدا لدى القيادة بأن نجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بالثقة. والثقة لا تولد من مؤتمرات، بل من إحساس الناس بأن الحكومة تُدير المعركة لصالحهم، لا ضدهم. أن هناك رؤية، وخارطة طريق، واستعداد حقيقي للتكيف مع المتغيرات، دون انكسار أو تهور.
وإذا كان الصيف هو الفصل الأصعب في اختبار التحمل، فإن المواطن المصري رغم كل الشكوى ، لا يزال يتحمل. يتحمّل لأنه يرى أن هناك دولة لا تهرب من المواجهة، ولا تبيع الوهم، ولا تُلقي الفشل على الآخرين. يتحمّل لأنه ببساطة يريد أن يعيش في وطن قوي لا في دولة رخوة.
إن ما يصنع الفارق بين التعافي والانهيار ليس فقط القرارات الاقتصادية بل القدرة على الحفاظ على اللحمة الاجتماعية، وعلى شعور الناس بأنهم جزء من المعركة لا ضحاياها. وكلما تم إشراك المواطن بالصدق، وبالبيانات، وبالتفسير، كلما زادت صلابته، وانخفضت احتمالات الانفجار.
وهذا هو التحدي الحقيقي أمام الحكومة في صيف 2025: ليس فقط السيطرة على سعر الصرف، أو الحد من التضخم، بل بناء علاقة جديدة مع الناس تقوم على الشفافية، والوضوح والإشراك لا على المفاجآت. لأن الاقتصاد في النهاية ليس معادلة حسابية بل عقد اجتماعي بين الدولة ومواطنيها.
في هذا الصيف قد تكون الفاتورة مرتفعة لكن الإرادة موجودة. وإذا صمدت الإرادة فكل فاتورة يمكن سدادها.