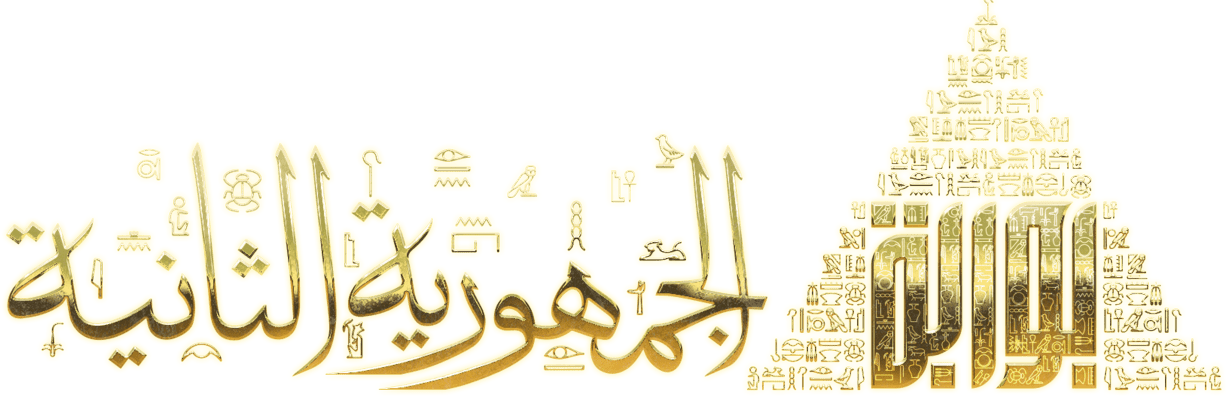شحاتة زكريا يكتب: الدراما العربية.. من صناعة الوعي إلى صناعة الضجيج

كانت الدراما العربية مرآةً للناس تعبّر عنهم بصدق وتنقل نبض الشارع إلى الشاشة بلغة الفن لا لغة المبالغة. كانت الحكايات تُروى لتبني وعياً لا لتملأ فراغا. كانت الشخصيات تنبض بالحياة تمثلنا وتعيش بيننا. لكن شيئا ما تبدل في الطريق شيئا جعل الدراما تفقد دورها التنويري وتتحول من صناعة الوعي إلى صناعة الضجيج.
في زمن لم تكن فيه وسائل التواصل تُغرق الناس بالصخب كانت الدراما هي الوسيلة الأقوى للتأثير. أعمال مثل ليالي الحلمية ورأفت الهجان ودموع في عيون وقحة وأرابيسك لم تكن مجرد مسلسلات؛ كانت منابر فكرية وثقافية تطرح الأسئلة الكبرى عن الوطن والهوية والانتماء. كنا نرى أنفسنا في أبطالها ونتعلم من حواراتها ونختلف مع نهاياتها لكنها كانت تترك فينا أثرا.
أما اليوم فكثير من الدراما العربية تبدو كما لو أنها فقدت البوصلة. تُنتَج الأعمال بالعشرات لكنها تمرّ مرور الضجيج ، بلا أثر. تتنافس القنوات على الموضوع الصادم لا على الفكرة الهادفة وتُقاس نجاحات المسلسلات بعدد مشاهداتها على المنصات، لا بقدرتها على تحريك ضمير المجتمع أو إثارة النقاش الواعي.
لقد أصبحنا أمام مشهد درامي مغاير تماما. الكاميرات لا تتعب والميزانيات تتضاعف، ولكن الرسالة تضيع وسط الزخارف التقنية والإيقاع السريع.
لم يعد الهدف هو الإقناع بل الترند لم تعد الشخصيات تُكتب لتُجسّد الإنسان العربي بتناقضاته بل لتثير الجدل وتُحدث ضوضاء رقمية مؤقتة.
هذه التحولات ليست صدفة بل نتيجة لعصر اختلط فيه الإعلام بالفن والاستهلاك بالفكر فاختزل البعض الدراما إلى وسيلة ترفيه آنية لا إلى أداة وعي اجتماعي. صار المشهد الصاخب أهم من الحوار العميق والموقف المثير أهم من القيم التي يبنيها.
حتى القضايا الكبرى — التي كانت تُطرح بجرأة وحكمة — صارت تُقدَّم اليوم إما بانفعال مفرط أو بتسطيح مخلّ.
الدراما التي كانت تفتح العيون على القضايا الاجتماعية والطبقية وتناقش علاقة الإنسان بالسلطة والمجتمع، أصبحت في كثير من الأحيان تُعيد تدوير الحكايات ذاتها: خيانة، انتقام، أزمات أسرية مفتعلة، دون رؤية فكرية أو بعد إنساني حقيقي.
كأننا أمام دراما استهلاكية تُقدّم للمشاهدة السريعة لا للتأمل الطويل.
لكن الخطر الأكبر ليس في ضعف بعض الأعمال بل في تغيير وظيفة الدراما نفسها. حين تتحول الدراما من وسيلة وعي إلى وسيلة تشويش ، يصبح المجتمع بلا مرآة حقيقية. فالفن الذي لا يصحّح الواقع يُكرّسه. والدراما التي لا تُنبه إلى الخلل تُساهم في تعميقه.
نعم هناك محاولات جادة ومشرقة لكنها قليلة وسط موجة من الإنتاج المتشابه.
أعمال مثل تحت الوصاية وسفاح الجيزة ورسالة الإمام أعادت التذكير بأن الدراما يمكن أن تجمع بين الجودة الفنية والرسالة الراقية.
لكنها تظل جزرًا مضيئة في بحر من الضوضاء.
إن الأزمة ليست في الممثلين ولا في التقنيات بل في غياب الفكرة المركزية.
الفن بلا رؤية يتحول إلى زينة بصرية مهما بلغت مهارة صانعيه.
نحتاج أن نُعيد الدراما إلى جوهرها: سؤال لا صرخة. رسالة لا جدلا. صوتا للعقل قبل أن يكون وسيلة للإثارة.
لقد كانت الدراما المصرية والعربية يوما أداة لتربية الذوق الجمعي وتشكيل الشخصية الواعية التي تُفرّق بين الخير والشر. كانت تُعالج الفقر والظلم والتفاوت الاجتماعي برقي لا بتهويل.
أما الآن فقد دخلت بعض الأعمال في سباق لتصوير الانحراف دون أن تضع له حدودا ولإبراز القبح دون أن تُقدم بديلا جميلا.
هكذا صار المشاهد يغادر المسلسل كما دخله: بلا وعي بلا فكرة وربما بقدر من التبلّد تجاه الواقع.
الفن ليس مسؤولا عن إصلاح العالم لكنه مسؤول عن أن يُضيء له الطريق.
الفنان الحقيقي لا يلهث وراء رضا الجمهور المؤقت بل يصنع ما يُبقي أثره في ذاكرة الزمن.
وعندما تُصبح الدراما رهينة الإعلانات وأرقام المشاهدات تضيع البوصلة ويتحوّل الفن إلى منتج استهلاكي يُستهلك سريعًا كما يُنسى سريعًا.
الدراما ليست سلاحا سياسيا ولا وعظا مباشرا، لكنها قادرة على بناء وعي جمعي وتشكيل ضمير عام وتحريك نقاش مجتمعي راق.
الدراما الراقية لا تُعلم الناس كيف يعيشون بل لماذا يعيشون، ولا تُلقّنهم دروسا بل تتركهم يُفكرون.
ما أحوجنا اليوم إلى العودة إلى تلك الروح التي صنعت الدراما الذهبية حين كان الكاتب يمتلك فكرا، والمخرج يمتلك رؤية والممثل يمتلك صدقا والجمهور يمتلك ذوقا.
حينها فقط كانت الشاشة نافذة للوعي لا مرآة للضجيج.
من المؤلم أن يتحول الموسم الدرامي إلى معركة أرقام بدلا من أن يكون موسمًا للفكر والإبداع.
ومن المؤسف أن نرى المسلسلات العربية تتنافس على الصراخ والعنف بدلا من أن تتسابق في تقديم معنى أو حلم أو وعي.
ومع ذلك يبقى الأمل قائما.
فالجيل الجديد من الكُتّاب والمخرجين يملك أدوات جديدة ورؤى مختلفة وإذا أُتيح له المناخ الحقيقي للإبداع يمكن أن يُعيد الدراما إلى مكانها الطبيعي: صناعة الوعي الجمعي ، لا صناعة الضجيج المؤقت.
لقد أثبتت التجربة أن الجمهور العربي — رغم كل ما يُقال — لا يزال يحترم العمل الصادق، ويتفاعل مع القصة التي تلامس وجدانه لا التي تُبهر عينه فقط.
فالفن الصادق لا يحتاج إلى ضوضاء ، بل إلى نبض إنساني حقيقي.
ويبقى السؤال مفتوحا:
هل نستطيع إعادة الدراما العربية إلى رسالتها الأولى أم سنواصل الدوران في فلك الإثارة اللحظية؟
الإجابة رهن بقدرة صُنّاع الفن على التذكّر: أن الدراما ليست مرآة لزمننا فحسب بل صانعة له أيضا.