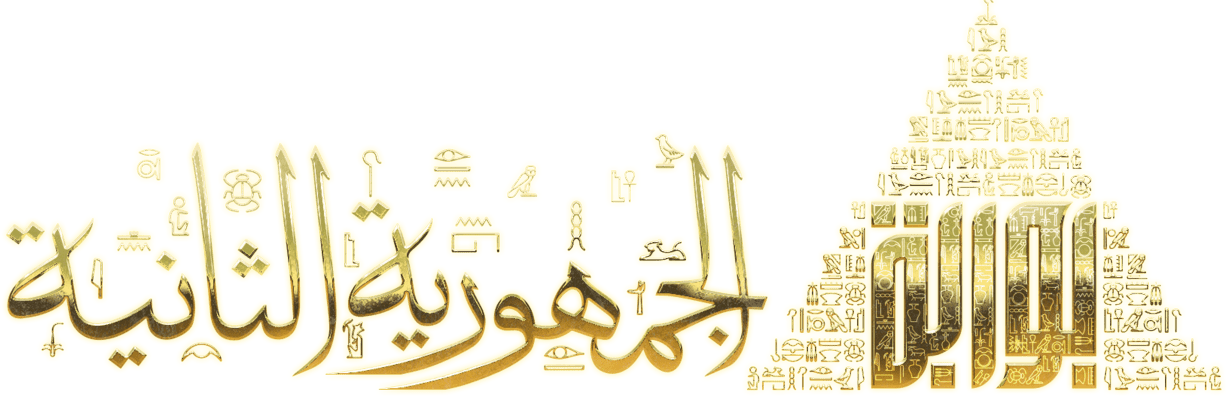سعد إبراهيم يكتب: ماكرون في القاهرة.. حين التقت حضارة النيل بروح الثورة الفرنسية

في زمنٍ تاهت فيه الجغرافيا، واختلطت فيه التحالفات، لم تكن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مجرد حدث دبلوماسي في جدولٍ مكتظٍ، بل مشهد متكامل كُتب بحبر التاريخ ومشاعر الجغرافيا، وصيغ بلغة لا تُترجم؛ لأنها تُفهم بالرمز وتُقرأ بالنبرة.
منذ لحظة هبوط طائرته، بدت الزيارة كأنها لقاء بين حضارتين لطالما تقاطعتا عند لحظات التحول الكبرى. فاستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي لا كضيفٍ عابر، بل كشريك في حلم إقليمي يتشكل وسط صراعات تتآكل فيها عدالة الشعوب وأحلامها.
في خان الخليلي، لم يكن ماكرون يتجول كسائح أوروبي يفتش عن صورة شرقية، بل كمثقف يلمس نَفَس الشرق في رائحة العود، وصوت النحاس، ودفء العيون. وهناك، ربما شعر أن مصر لا تُقاس بمؤشرات التنمية فقط، بل بذاكرة حضارية تعرف كيف تحوّل الحكاية إلى سياسة، والرمز إلى قرار.
لكن الحكاية لم تتوقف في القاهرة، بل امتدت إلى العريش، حيث الجراح الفلسطينية لا تُروى بالكلمات بل تُقرأ في العيون، والحقيقة أكثر حِدِّة من الخطاب. جلس الرئيس الفرنسي إلى جوار جرحى غزة، أولئك الذين حملوا أثقالاً أكبر من جراحهم، وقال أحدهم بصوتٍ مشبع بالإصرار: “عاوز أرجع لبلدي، ولو في كفن.”
هنا توقف ماكرون، لم يُجب. فقط أومأ برأسه، وكأن شيئًا داخله تصدّع. في تلك اللحظة، أدرك أن القضية ليست ورقة سياسية، بل كرامة تبحث عن جغرافيا تحتضنها. لم يكن ماكرون ممثلًا لأوروبا فقط، بل شاهدًا على الإنسانية وهي تحاول أن تنتصر، ولو للحظة، على ركام السياسة. – كان المشهد صامتًا، لكنه صاخب بالمعنى -: أن هذه الأرض لا تنكسر، وأن من فيها لا يساوم على الذاكرة.
وفي لحظة وداعٍ، اختارت مصر ألا تغلق الصفحة بهدوء . في مشهد يحمل دلالات السيادة وصدق الانتماء، حلّقت نسور الجو بطائرات الرافال وكأنها تجسّد روح الشراكة والوفاء، مودّعة الرئيس الفرنسي بتحية تليق بالمقام، ورسالة ودّ ، بلسان الحال تقول: “شراكتنا لا تنتهي على الأرض فقط، بل تمتد إلى السماء.”
لم تكن هذه التحية مجرد مشهد جوي مهيب، بل كانت رسالة بصرية للعالم: أن مصر، وهي تكرّم حليفًا، تفعل ذلك لا من موقع التبعية، بل من قمة السيادة.
لكن ما بعد الزيارة حمل دلالاتٍ أعمق. ففرنسا قررت أن تترك أثرًا على أرض الكنانة لا يمحوه الزمن: مدارس فرنكوفونية تُنير الفكر، ومستشفى لعلاج السرطان يُنبت الأمل، ومصانع سلاح تُشيّد فيها الريادة، لم تكن مصر فقط مستقبِلة، بل شريكة في التأسيس لمرحلة جديدة، حيث العلاقات لا تُبنى على المجاملات، بل على العقول المنتجة، والمواقف المستقلة، والرؤية الواضحة.
أما العواصم العربية، فقد ارتبك صمتها للحظة، ثم بدأت الهواتف ترن في باريس: ملوك ورؤساء، من الخليج إلى الشام، يسألون عن طبيعة هذا التحول، عن سر الحضور الفرنسي في قلب القاهرة بهذا الشكل الحميمي والإستراتيجي، وكأن مصر فجأة عادت لتكون مركز الجاذبية في إقليمٍ تتنازعه المصالح والخسارات.
وكان لافتًا حضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لا كمتفرج، بل كمقاتل في خندق واحد، يحمل همّ الفلسطيني كما يحمله الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول للعالم: “فلسطين ليست صدى ماضٍ، بل اختبار حاضر، وشرف أمة.”
في تلك اللحظة، كتبت القاهرة فصلاً جديدًا من فصول التاريخ بهدوء. لم تُرفع فيه شعارات، ولم تُطلق فيه خطب حماسية، لكنه فصل قال الكثير: أن الشرق إذا قرر أن يتكلم، يتكلم بلغته، وأن القاهرة إذا قررت أن تتحرك، تتحرك بثقل الحضارة، لا برداء الاستعراض.
لقد كانت زيارة ماكرون لمصر مشهدًا مركبًا لا يُختزل في بروتوكول ولا يُقاس بعدد الاتفاقيات، بل لحظة نادرة التقت فيها حضارة النيل بروح الثورة الفرنسية، على أرض تعرف كيف تحفظ القديم، وتصوغ الجديد. زيارة أعادت التأكيد أن مصر لا تزال قادرة على أن تكون لاعبًا لا يُستثنى، ومركزًا لا يُلتف حوله، ومُلهِمة في زمن قلَّ فيه الإلهام.