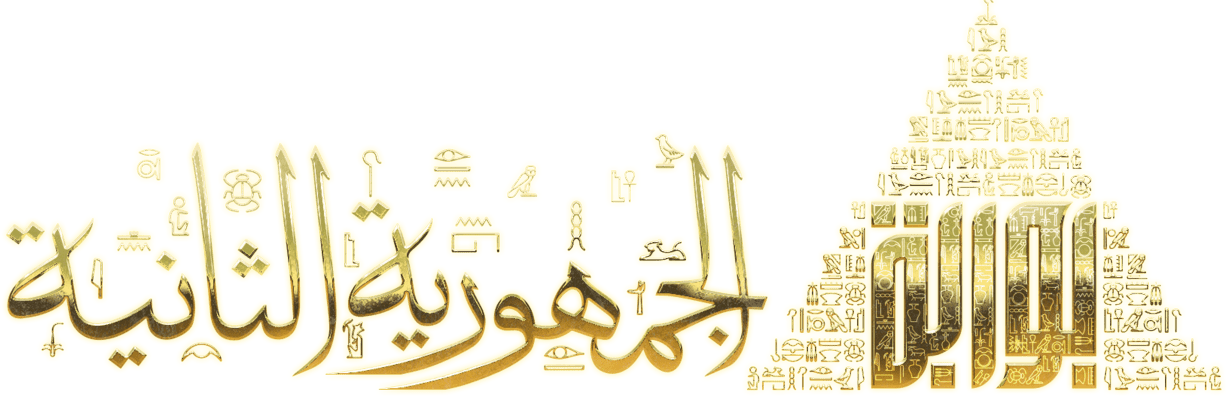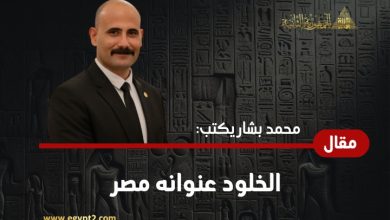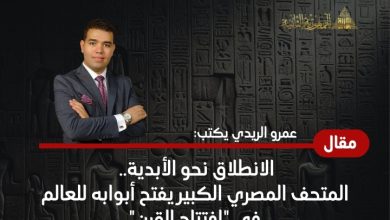المعرفةKnowledge كانت وستظل محوراً هاماً لتطور الأمم والمؤسسات والأفراد، وتعرف المعرفة على أنها: كافة الأرصدة المتوافرة لدى الإنسان من بيانات ومعلومات وآراء ومعتقدات وخبرات واتجاهات وانطباعات وتصورات ذهنية والتي تعد المرجع الأساسي له في التعامل مع كافة متطلبات الحياة.
وينبغي أن نفرق بين المعرفة في اللغة، والمعرفة كإصطلاح إداري.
المعرفة في اللغة، هي نقيض الجهل، أو ما دل على معينٍ مقابل النكرة هي إدراك الشيء على حقيقته بشكل جازم.
المعرفة كإصطلاح إداري: هي عملية فهم وإدراك للحقائق والمفاهيم من خلال التفكير واكتساب المعلومات سواء عن طريق التجربة أو التعليم. وهي تمثل مزيجاً فريداً من المعلومات، والحقائق، والمفاهيم، والقواعد، والإجراءات، والأحكام المكتسبة من التجربة والفهم النظري والتطبيقي. وتتضمن المعرفة كافة الخبرات والمهارات التي يكتسبها الفرد من خلال التعليم والتدريب والممارسة.
والمعرفة عزيزي القارئ ليست ساكنة، بل هي عملية ديناميكية قابلة للتطور والتراكم. وتسمح المعرفة للأفراد والمؤسسات بخلق أوضاع جديدة وقيادة التغيير.
وتختلف المعرفة عن كافة الموارد الطبيعية من بترول وغاز وفحم وذهب وغيرها من الموارد لأن تلك الموارد الطبيعية ليست مستدامة، بل تنفد بالاستخدام. بينما المعرفة لا تنفد .. بل على العكس تتزايد بالاستخدام والتداول.
إذا تعتبر المعرفة مكوناً استراتيجياً في صناعة التميز المؤسسي وتعزيز الإنتاجية وصناعة ثروة وطنية، وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتفاعل الثقافي. تشكل المعرفة اقتصاد جديد يطلق عليه “اقتصاد المعرفة”. اقتصاد المعرفة هو اقتصاد وفرة.. بينما الاقتصاد التقليدي هو اقتصاد ندرة.
والمعرفة بحدّ ذاتھا غیر قابلة للإدارة، إلا أن صناعتھا وتحویلھا تُعَدُّ عملیات قابلة للإدارة. ولقد ظهر مصطلح إدارة المعرفة كمفهوم لأول مرة في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وهو يشير إلى تحدید المعلومات المھمة، واستخلاصھا، ونقلھا إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب. كما يشير اصطلاح إدارة المعرفة إلى استخدام القدرة العقلية للمؤسسات بطريقة منهجية ومنظمة لتحقيق الكفاءة المنشودة وضمان التميز المؤسسي. وأخيراً يشير مصطلح إدارة المعرفة إلى ذلك الجهد المؤسسي والمنهجي للإستفادة من المعرفة التراكمية التي تكونت لدى أي منظمة وامتلكتها عبر السنين.
ولقد ظهر علم إدارة المعرفة نتيجة لعدة أسباب منها:
1. التدفق العشوائي للكثير من البيانات والمعلومات بشكل غير مفلتر وغير معالج.
2. تعدد المصادر التي تتواجد فيها المعلومات ( فبعضها سهل الوصول إليه/ وبعضها صعب الوصول إليه لكونه شخصي للغاية).
3. الحاجة للوصول للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.
4. تباين الجهات الطالبة للمعلومات وفي عدة صور متضاربة.
5. صعوبة الوصول للمعلومات المطلوبة وقت الذروة بسبب حدوث اختناقات في شبكات الحاسوب.
6. تجزئة المعلومات وتناثرها في أماكن كثيرة داخل المنظمة وخارجها.
7. التخصصية الشديدة في العمل، والتي جعلت الأشخاص لا يمتلكون المعلومات بشكل متكامل بل بشكل جزئي.
8. تنوع القوى العاملة وانتشارها داخل المنظمات.
9. تزايد معدلات دوران العمل (ترك العمل) حيث أظهرت العديد من الدراسات أن هناك بشكل ملحوظ قصر متوسط السنوات التي يقضيها الموظفين في وظيفة معينة في منظمة معينة.
10- معظم المعرفة تخزن في أذهان الموظفين (42% من معارف المنظمات) بينما تخزن 26% من المعرفة فقط على الورق، 20% فقط من المعرفة تخزن الكترونياً.
11- ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وانتشارها بشكل موسع قد أسهم في نمو وتداول وإدارة المعرفة.
12- كثرة التطبيقات التقنية قد أسهم في إدارة المعرفة بشكل دقيق.
ويوجد نوعين من المعرفة:
أ- المعرفة الضمنية Tacit Knowledge
ب- المعرفة الظاهرة Explicit Knowledge
ويقصد بالمعرفة الضمنية تلك المعرفة التي يصعب التعبير عنها وتوظيفها في نصوص أو رسومات، ولكنها تميل إلى التواجد في عقول العارفين.
بينما يقصد بالمعرفة الظاهرة أو الصريحة ذلك المحتوى المُجسّد في شكل ملموس كالكلمات أو التسجيلات الصوتية أو الصور. عادة ما تكون المعرفة الصريحة محصورة في وسائط ملموسة.
ولا يمكن أن تنجح عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات العربية إلا من خلال توافر مجموعة من المقومات الرئيسة منها:
1- دعم القيادة العليا.
2- توافر تنسيق استراتيجي.
3- توافر مجموعة من المبادئ و اسس للحوكمة.
4- توافر هيكل مؤسسي داعم للمعرفة.
5- السماح بالتقاط المعرفة ونشرها وتبادلها.
والنقطة الأخيرة، هي ما نود أن نركز عليها في هذا المقال “مشاركة المعرفة” حيث يفترض نظرياً أن كافة الموظفين باحثون عن المعرفة.. سواء داخل أي منظمة أو خارجها. ولكن عملياً، يشير الواقع التطبيقي إلى وجود “أمية معرفية” ولابد من تدخل إدارات المؤسسات من أجل محو أمية المعلومات.
ويقصد بمحو أمية المعلومات هي عملية تعزيز قدرات الموظفين من أجل:
1- التعرف على نوعية المعلومات المطلوبة.
2- التعرف على توقيت الاحتياج للمعلومات.
3- توافر القدرة على تحديد موقع المعلومات.
4- توافر القدرة على تقييم المعلومات المتاحة.
5-توافر المعرفة بطرق فعالة لاستخدام المعرفة.
ويشير الواقع العملي في المؤسسات العربية، أن معظم تلك المؤسسات لا يتم فيها مشاركة المعرفة ولا حتى إدارتها، بل الغالب فيها هو سريان حالة من حالات (اكتناز المعرفة) أو ما يطلق عليها ثقوب المعرفة السوداء Knowledge Black holes حيث يميل معظم الموظفين في المؤسسات العربية إلى الحصول على المعرفة ثم اكتنازها وعدم استمرار تداولها مع الآخرين واعتقد، أن الأسباب وراء هذه السلوكيات عديدة، نختصرها فيما يلي:
1. الأعتقاد بأن المعرفة ملكية خاصة.
2. الأعتقاد أن الناس يكافئون على ما يعرفون وليس على ما يشاركون، لذلك يخزنون المعرفة، و يتسبب هذا في إعادة اختراع العجلة، والشعور بالعزلة ومقاومة الأفكار الجديدة سواء من داخل أو خارج المنظمة.
3. الاعتقاد أن من سيتقبل المعرفة لن يفهمها بالشكل الصحيح وإذا فهمها فلن يستخدمها بالشكل الصحيح.
4. تفشي الثقافة التنظيمية التي تنمي منهج العبقرية الفردية مع عدم توافر ثقافة تنظيمية تشجع على العمل الجماعي وخلق مناخ من الثقة.
5. عزوف الكثير من الموظفين عن استخدام مستودع المعرفة التنظيمي (مستودع المعرفة الرسمي) والاعتماد بشكل كبير على شبكاتهم الخاصة.
6. الاعتماد الدائم على دفع المعرفة من أعلى لأسفل، وعدم تشجيع الموظفين على جعل تبادل المعرفة (مبادرة شعبية من الموظفين أنفسهم) والاحساس أنها شريان حياة بالنسبة لهم.
إن القضاء على تلك المعوقات، سيفتح الباب أمام عمليات مشاركة المعرفة وتبادلها، وتكوين مستودعات فكرية تفيد المنظمات وتسهم في تطورها، كما ستساعدها على مواجهة التحديات البيئية وخاصة ظروف المنافسة الضارية.
ولكن هذا الأمر، يتطلب إدارة إحترافية، ومنظومة متكاملة من “القوى العالمة” وليس القوى العاملة.. ترى لماذا؟ للحديث بقية بمشيئة الله تعالى .
الكاتب: الأستاذ الدكتور هشام البحيري
أستاذ إدارة الأعمال – بجامعة القاهرة
أستاذ إدارة الموارد البشرية – بكلية التجارة – جامعة البريمي – سلطنة عمان