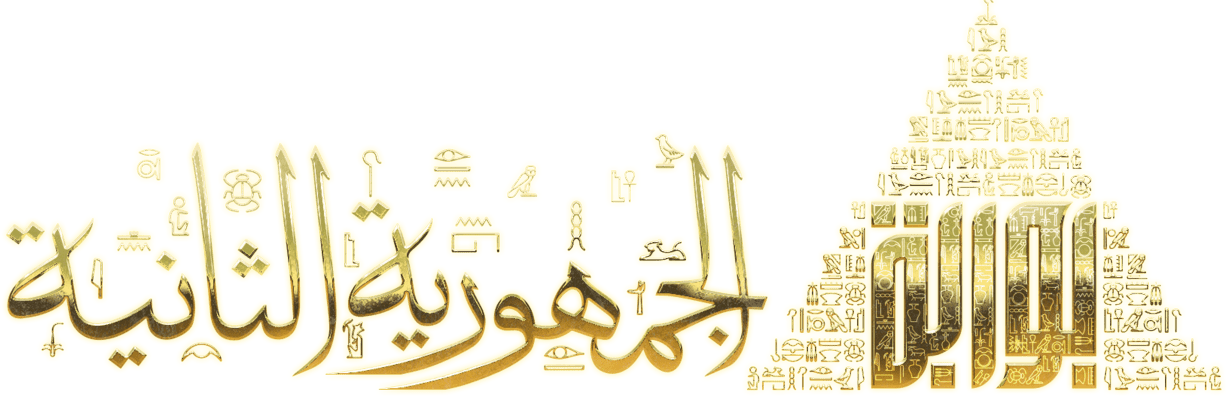تهجير سكان غزة وما توارى من الأهداف الإسرائيلية للحرب.. القصة كاملة

إعداد: أحمد التلاوي
تتعدَّد أبعاد القضية الفلسطينية، وربما لم تشكِّل الأمم المتحدة لجانًا لقضية أخرى مثلما شكَّلت للقضية الفلسطينية على تعقيدها، وتشابك ملفاتها، إلا أنها تبقى في النهاية، أن قضية اللاجئين، هي عَصَب القضية، وأساسها، وتعتبرها إسرائيل بمثابة العقدة الأساسية التي تواجهها لتثبيت وجودها غير الشرعي في المنطقة.
فصُلب المشروع الصهيوني / القضية الفلسطينية، هي أن هناك شعب أو مجموعة بشرية، أيًّا كانت هويتها، تم إحلالها، أو لا تزال محاولات تثبيت ذلك قائمة، محل شعب آخر على نفس الأرض، مع رفض قسم كبير من كلا الطرفَيْن السماح للآخر بمشاركته فيها.
ولذلك، لن نقول أولَت إسرائيل وحلفاءها عناية خاصة بهذه القضية، ولن نقول إن الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية انخرطت في جهد كبير داخل فلسطين، وخارجها لمعالجة هذه المسألة، من قبل إعلان قيام دولة إسرائيل في مايو من العام 1948م على أراضي الدولة اليهودية وجزء من أراضي الدولة العربية في فرار التقسيم الشهير رقم (181)، على وضوح أهداف المشروع الصهيوني.
وبالرغم من تعدد آليات هذه الهيئات وداعميها من كبار بيوت المال اليهودية في العالم، وعلى رأسها عائلة روتشيلد، من أجل تحقيق هدف إحلال واستيطان اليهود محل الفلسطينيين على أرضهم، بما في ذلك شراء الأراضي، وممارسة الضغوط على السكان الأصليين، وترحيل بعضهم طوعًا من خلال حوافز مادية، أو قسريًّا، واستيطان الأراضي غير المأهولة بالسكان، إلا أن الأداة الرئيسية كانت الإرهاب المسلح.
خلفية تاريخية وقانونية
في الفترة بين العامَيْن 1947م و1948م، نجحت العصابات الصهيونية، وعلى رأسها الـ”هاجاناه” التي صارت بعد ذلك عماد الجيش الإسرائيلي، في طرد ما بين 700 ألف فلسطيني، بحسب أرقام الأمم المتحدة، و960 ألفًا بحسب إحصائيات منظمات وهيئات فلسطينية، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يسكنون فلسطين التاريخية وقتها.

وصار هؤلاء يُعرَفون بـ”اللاجئين”، وينظِّم أوضاعهم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، ثم أضيفت إليهم أعداد أخرى بعد حرب يونيو من العام 1967م، بين 280 إلى 350 ألف فلسطيني، وحمل هؤلاء مسمى “نازحون” وكان من بينهم 145 ألفًا من لاجئي الـ48، ويدخلون ضمنًا في قرار مجلس الأمن رقم (242) الصادر بعد حرب يونيو الذي ينص على عودة الأوضاع في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في هذه الحرب إلى ما قبل الخامس من يونيو.
ولكن القرار (194) كان يتعامل مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية فقط برغم أنه نصَّ صراحةً على حق عودتهم، لكن هذا التوجه تغيَّر في العام 1970م، في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2649)؛ حيث تعاملت معه الأمم المتحدة للمرة الأولى كـ”شعب له حق قانوني ثابت في تقرير مصيره”.
هذا الرقم تطور خلال العقود الماضية التي تلت النكبة، وحرب يونيو، إلا أنه ظل دائمًا يدور حول وجود نصف الفلسطينيين في داخل فلسطين بأقسامها المختلفة، ونصفهم خارجها، لاجئون أو نازحون، مع وجود فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مُصنَّفين في الفئتَيْن؛ لاجئون أو نازحون، ولذلك؛ فإن الضفة وغزة منطقة من ضمن مناطق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبقي هنا أنْ نشير إلى أن القرار رقم (3236) الصادر عن الجمعية العامة في العام 1974م، جَعَل حق العودة للاجئين والمُهَجَّرين بسبب الحرب، أي حرب، هو حق غير قابل للتصرُّف، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان في وقت الحرب، التي صدرت عام 1948م.
وبلغ تعداد الفلسطينيين منتصف 2024م، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حوالي 14.8 مليون، نصفهم في فلسطين التاريخية، منهم 5.6 في الضفة وغزة، و1.8 في إسرائيل، ويعرفون بـعرب إسرائيل” أو “عرب الداخل” أو “عرب 48″، ويمثلون 21% من تعداد السكان، بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

كل هذه الاستطرادات التاريخية والقانونية والإحصاءات فقط من أجل الإشارة إلى تعقيد هذه القضية في حد ذاتها، وتضع على الكيان الصهيوني عبئًا أمنيًّا وديموجرافيًّا كبيرًا؛ حيث جزء من المشكلة موجود داخل الدولة العبرية ممثلاً في عرب الداخل، والذين يتزايدون بوتيرة أسرع من نسب زيادة سكان الدولة من اليهود.
وتنظر إسرائيل إلى هذه القضية نظرة شاملة، تدرك خطرها الوجودي عليها، فلديهم – مثلاً – ما يُعرَف في الأدبيات السياسية والإعلامية الإسرائيلية بـ”القنبلة الديموجرافية”، والتي تعني بالنسبة لليهود كابوسًا مقيمًا، لأنها ترتبط بحالة التوازن الديموجرافي بينهم وبين العرب، فلغرابة الأقدار، فإن عدد يهود العالم يقترب أيضًا من 15 مليونًا، نصفهم تقريبًا يعيش في إسرائيل!
صداع في رأس إسرائيل
تتخوَّف إسرائيل دائمًا – وربما كان هذا لديهم في مدونات الأمن القومي لمؤسساتهم الأمنية والعسكرية – من فكرة زيادة عدد السكان العرب عن اليهود في سائر فلسطين، وليس في أراضي الـ48 فحسب، وإنما أيضًا الأراضي المحتلة عام 1967م، وبخاصة الضفة الغربية، أو يهود السامرة وفق المسمَّى الإسرائيلي، والتي هي جزء مهم من الأساطير الدينية والتاريخية التي بنى اليهود عليهم المشروع الصهيوني في فلسطين.
وتطورت خطط إسرائيل لتخفيض عدد الفلسطينيين الموجودين في فلسطين، فقبل حتى إعلان قيام الدولة كما ذكرنا، قدمت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية، تصورات مختلفة لمعالجة هذه المشكلة، وكان من بين أهم ما فيها، وسوف نجده يتكرر دائمًا في الوثائق الإسرائيلية، هو تهجير الفلسطينيين إما إلى شرق الأردن أو إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
فشرق الأردن، أو إمارة شرق الأردن، والتي صارت المملكة الأردنية الهاشمية في العام 1946م، كانت في الأصل جزءًا من فلسطين الانتدابية، بينما سيناء – وهذه المشكلة استمرت بعد ذلك لعقود طويلة – كانت نقطة الجذب فيها، هي أنها صحراء غير مأهولة بالسكان، باستثناء بعض التجمُّعات البدوية.
وبعد حرب يونيو 1967م، طرح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إيجال آلون خطته المعروفة باسمه، “خطة آلون”، والتي كانت تعالج أمرَيْن مهمَّين لدى إسرائيل، في نسق إستراتيجي واحد، وهما مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والمناطق التي احتلتها إسرائيل في الحرب، وتضم تجمعات سكانية عربية السكان العرب، ومعالجة التشوهات الجيوسياسية الموجودة في شكل الدولة، مثل انبعاج الأردن وانبعاج غزة، والتي تمثل نقطة ضعف لأية ترتيبات دفاعية بالنسبة لإسرائيل.
وفي حقيقة الأمر؛ فإن “خطة آلون” ظلت هي أساس كل الخطط والتحركات الإسرائيلية في هذا الموضوع، ملف اللاجئين، ومستقبل قطاع غزة والضفة وغور الأردن، ونظرة إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ترتيبات الدفاع عن الدولة وفق المنظور السابق.
حتى إنها كانت في صلب تصور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال وجوده في السلطة، وفق ما رشحت من تسريبات لخرائط ما كان يطلق عليه “صفقة القرن”، والتي تتضمن تبادلاً للأراضي بين مصر وإسرائيل، بحيث يحصل الفلسطينيون على جزء من منطقة المثلث الواقع بين العريش وحدود قطاع غزة، نظير حصول مصر على منطقة ميتة من الصحراء الواقعة داخل الحدود الإسرائيلية في منتصف خط الحدود تقريبًا بين مصر وإسرائيل.
تقوم “خطة آلون” على أساس تقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والمملكة الأردنية، وإقامة دولة درزية في هضبة الجولان الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى مصر، وبالتحديد الأراضي المأهولة بالسكان.
فلمعالجة مشكلة الانبعاج الأردني في شكل الدولة العبرية، نصَّت الخطة على ضم معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وكتلة “جوش عتصيون” الاستيطانية إلى إسرائيل، وهو بالضبط ما تقوم به حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو حاليًا، والحكومات اليمينية والعُمَّالية والعلمانية التي تولت الحكم في إسرائيل طوال العقود الماضية.
أما الأجزاء الباقية من الضفة الغربية، التي يقطن فيها غالبية السكان الفلسطينيين، تصبح أراضٍ للحكم الذاتي الفلسطيني، أو تؤول إلى الأردن، بما في ذلك ممر إلى الأردن من خلال أريحا، ولكن هذا التصور رفضته الأردن، وبالتالي؛ كان أساس اتفاقيات أوسلو التي وقَّعتها إسرائيل مع منظمة الفلسطينية في التسعينيات.
أما بالنسبة لما يخص هضبة الجولان من الخطة، فإن حكومة اليمين التي كان يقودها مناحيم بيجين في إسرائيل، صادقت على قانون بضمِّها في العام 1981م، والتي تضم غالبية هضبة الجولان التي احتلها إسرائيل في حرب 1967م.
الخطة تمَّ وضعها بناء على اعتبار مهم فيما يتعلق بالقضية الديموجرافية، وهي أنْ تضم الحدود النهائية لإسرائيل – والتي لم توضع للآن – أقل عدد ممكن من العرب، وهو ما نجده واضحًا في اتفاقيات أوسلو؛ حيث تم استبعاد دمج المناطق ذات الكثافات السكانية العربية من الضفة الغربية باعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى تغيير جذري للطابع الديموجرافي اليهودي للدولة.
“حماس” والدور الأسود
طوال سنوات الفوضى التي تلت ثورات ما عُرِف بـ”الربيع العربي”، والذي كانت مصر محطته الثانية بعد تونس، ظهرت إلى الأفق خطط إسرائيل لاستغلال فرصة ضعف الدولة المصرية، وتحقيق جانبًا مهمًّا من الخطط التي بدأتها الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية قبل ذلك بنحو قرن من الزمان، ووضعتها “خطة آلون” موضع التنفيذ.
وكانت “حماس” جزءًا أصيلاً من هذه السياسة الإسرائيلية، بشكل عَمْدِيٍّ، ولا يتعلق الأمر بتأثيرات ما قامت بها إسرائيل بأساليب أجهزة الاستخبارات المعروفة، على قيادة الحركة، لتوجيهها بما يخدم مصالحها – مصالح إسرائيل – في عملية تصفية ملف اللاجئين.

ونشير هنا إلى بعض الأمور التي جرت في السنوات الماضية، وتؤكد هذا الأمر.
في التسعينيات، بدأت الولايات المتحدة في استغلال الأجواء التي أحدثتها اتفاقيات أوسلو بين العامَيْن 1993م و1995م، وقامت مع دول غربية عِدَّةٍ بتقديم حوافز للاجئين الفلسطينيين من أجل الهجرة، والتوطُّن في هذه البلدان، نظير تخلِّيهم جنسيتهم الفلسطينية، وأية مطالب متعلقة بقضية اللاجئين في فلسطين التاريخية، سواء ما صار منها إسرائيل، آو في مناطق الـ67.
وكان تمويل هذه العملية يتم من جانب بيوت المال الصهيونية اليهودية والمسيحية المحافِظة، الأمريكية والبريطانية، وهذا الأمر حتى دَفَع منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة إلى إعادة التأكيد على أن حق العودة للاجئين، هو حق غير قابل للتصرُّف بموجب القانون الدولي، حتى لو أراد اللاجئ ذلك.
ومثلما فعلت الولايات المتحدة ذلك وقت أوسلو، حاولت تكراره مع مصر والأردن بالتحديد لتصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين استغلالاً لما جرى في سنوات ما يُعرَف بثورات “الربيع العربي”.
فكان ان ــ توصَّلت أجهزة الدولة المصرية إلى تفاصيله في السنوات الماضية – أن مارست الولايات المتحدة تأثيرات على تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، وفرعه أو مركزه الرئيسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لتقديم دعم لموقف الإخوان السياسي في مصر، وتطبيع وجودهم في السلطة بعد تنحي الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك على إثر أحداث يناير وفبراير 2011م، نظير التعاون في تنفيذ “خطة ألون” في سيناء.
هذه التأثيرات أخذت مساراتها وفق اعتبارات التنظيم، إلى حركة “حماس”، التي هي ذراع التنظيم الإخواني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ورأينا كيف حاولوا خلال فترة حكم الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، توسيع مناطق نفوذهم في شبه جزيرة سيناء.
وتعددت الأساليب التي تبناها التنظيم وذراعه الفلسطيني، بما في ذلك طباعة بطاقات رقم قومي مصرية لفلسطينيين، بعد اقتحام مقر السجل المدني بالعريش، والاستيلاء على أدوات التصوير والطباعة الخاصة به، بالإضافة إلى تسهيل عملية حصول عدد كبير من الفلسطينيين على الجنسية المصرية، وهو ما حاول تعطيله اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية في حكومة هشام قنديل بين أغسطس 2012م ويناير 2013م.
وكانت هناك مفاوضات “رسمية” للحركة شملت رئاسة الجمهورية، وقت وجود مرسي في المنصب، ومع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
وعندما رفض مرسي المطالب التي أتت بها قيادات “حماس”، وكان منهم موسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية وخالد مشعل، في سيناء، باعتبار أن القوات المسلحة لن تقبل بذلك؛ لجأوا إلى مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، الذي كان يمارس السلطة الحقيقية في مصر وقت وجود مرسي في الحكم.
وهناك اجتماع شهير تم يوم الأربعاء التاسع والعشرين من أغسطس 2012م، شكا فيه قيادات “حماس” لمكتب الإرشاد موقف مرسي، فكان ان تمت دعوة عصام الحداد الذي تم قبل ذلك بأيام تعيينه مساعدًا مرسي للشؤون الخارجية لبحث المسألة مجددًا مع مرسي.
وكان العرض الذي قدمته “حماس” يكاد يتطابق مع تصور وضعته أجهزة الدولة العبرية في نهايات التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، يتضمن تصورها لشكل الدولة والمجتمع، والعلاقات مع الجيران، وتصور إسرائيل للتسوية النهائية مع الفلسطينيين، وتضمن ذلك تصورًا لتحويل قطاع غزة ومناطق شمال سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع إلى منطقة حرة، يكون لميناء ومطار العريش دور كبير في ذلك.
وبالفعل، وفق الترجمة التي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية للخطط الإسرائيلية في عدد من الكتب التي صدرت في ذلك الوقت، يتطابق ذلك مع ما طرحه هنية في زياراته المتكررة إلى مصر مع قيادات الحركة الآخرين، وتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
وطلبت “حماس” وقتها – كخطوة أولى – من رئاسة الجمهورية ومكتب الإرشاد، تقديم تسهيلات لشراء أراضٍ في شمال سيناء، وتوطين فلسطينيين فيها، بعد حصولهم على الجنسية المصرية.
ولذلك أصدر وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قرارًا في الثالث والعشرين من ديسمبر 2012م، بمنع تملُّك الأراضي والمباني، أو حتى الإيجار أو حق الانتفاع أو أي شكل من أشكال التعاملات في سيناء، لغير المصريين أصلاً ونسبًا، فشَمِلَ هذا القرار المصريين المُجَنَّسين؛ أيًّا كانت أصولهم.
وبعد الإطاحة بمرسي ونظام الإخوان في مصر، بدأت العمليات الإرهابية في شمال سيناء، والتي استهدفت رموز الدولة، وبخاصة القوات المسلحة والشرطة المدنية، بالإضافة إلى الأجهزة المحلية والقضاء وغير ذلك، من أحل إفراغ المنطقة من أية سلطة رسمية.
وتورطت عناصر من “حماس” في هذه العمليات، ولم تنفِ قيادات الحركة ذلك لمسؤولي المخابرات العامة الذين كانوا يجتمعون بهم من أجل معالجة الموقف في منطقة الحدود الشرقية لمصر مع سيناء، ولكنهم – قيادات الحركة – زعموا أنها عناصر منفلتة منهم، بينما الأدلة تقول بأنها كانت سياسة رسمية مقصودة من حركة “حماس”.
فقدمت الحركة كل أشكال الدعم الممكنة لعناصر المجموعات الإرهابية التي كانت تنشط في شمال سيناء على اختلاف ألوان طيفهم التنظيمي، حتى أن الحركة كانت تقدِّم مساعدات طبية للعناصر الإرهابية التي كانت تصاب في المواجهات مع الجيش والشرطة المصريتَيْن، في مستشفيات المناطق المتاخمة لحدود غزة مع شمال سيناء، خاصة مستشفى “ناصر” القريب نسبيًّا من منطقة الحدود.
كما أنه عقلاً، ليس من المقبول هذا الادعاء؛ حيث “حماس” تسيطر على قطاع غزة بالكامل، وحتى الآن، برغم كل الخسائر التي مُنِيَ بها الجهاز السياسي والعسكري للحركة في غزة بعد عام من الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ينفي تمامًا فكرة عدم ضبط “حماس” لعناصرها هي نفسها، “حماس” التي قضت على أي شكل من أشكال التمرُّد في غزة، سواء من جانب حركة “فتح” أو تنظيمات السلفية الجهادية الأخرى.
وهناك واقعة شهيرة استعملت فيها “حماس” القوة مع جماعة “جند أنصار الله” عندما أعلن أميرها عبد اللطيف موسى من مسجد “ابن تيمية” في رفح الفلسطينية، إمارة إسلامية، في الرابع عشر من أغسطس 2009م، فكان أن قامت “حماس” بتصفية زعيم الحركة وأنصاره بالكامل، وتفجير منزله.
وهنا من المهم العودة قليلاً بالتاريخ إلى الوراء، إلى الثالث والعشرين من يناير 2008م، بعد بضعة أشهر من الحسم العسكري لـ”حماس” لأزمتها مع حركة “فتح” بالقوة، في صراع السلطة والسيطرة بينهما في غزة في يوليو 2007م، عندما قامت عناصر من “حماس” بتفجير جزء من الحدود مع مصر، بالقرب من معبر رفح، مما أدى إلى تدفُّق مليون ونصف فلسطيني إلى سيناء، وهو نفس السيناريو الذي تم يوم “جمعة الغضب” 28 يناير 2011م، عندما تسللت عناصر من الحركة إلى داخل سيناء، ثم إلى وادي النيل بعد اقتحام الحدود بالمتفجرات والجرافات.
المعلومات وقتها – 2008م – أشارت إلى أن إسرائيل كانت على استعداد لاستخدام القوة في هذه المنطقة تحت زعم مخاوف من استيلاء عناصر “حماس” على أسلحة من القوات المصرية، وهذا أيضًا نعلم أن “حماس” والحركات التي كانت تساندها في شمال سيناء، حاولته في سنوات ما بعد 2013م.
عاد الدور الأمريكي الأسود إلى الإطلال برأسه في هذا الملف، عندما استغلت الولايات المتحدة الموقف – مثلما فعلت في التسعينيات وبعد فوضى 2011م – فقدَّم ترامب خطته الشهيرة المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي كانت تتضمن قبل الإعلان عنها رسميًّا في الثامن والعشرين من يناير 2020م، تبادلاً للأراضي بين مصر وإسرائيل كما ذكرنا، من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة المثلث في شمال سيناء، من رفح المصرية وحتى العريش.
ولكن ذلك قوبل برفض رسمي مصري، وأخدت الدولة المصرية سلسلة من الإجراءات في هذه المناطق المهددة بالسَّلخ عن الوطن، شملت تعزيز قرار وزير الدفاع المشار إليه بقوانين وقرارات تنفيذية أخرى، ولذلك – وفق وكالة “فوكس نيوز” الأمريكية وقت إعلان الصيغة الرسمية لـ”صفقة القرن” – تأخر الإعلان عنها لثلاث سنوات تقريبًا.
خطة ترامب تضمنت الهيكل العام لـ”خطة آلون” باستثناء غور الأردن، ولكن بعد عودة بنيامين نتنياهو من واشنطن بعد أنْ حضر الإطلاق الرسمي لخطة ترامب، دعا إلى تقديم مقترح إلى الكنيست بضم غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى اليهودية في الضفة إلى إسرائيل؛ تنفيذًا لأحد أهم بنود “خطة ألون”.
حرب غزة و خطة الجنرالات
تتداول وسائل الإعلام حاليًا مصطلح “خطة الجنرالات”، والتي تقوم إسرائيل حاليًا بتنفيذها في شمال قطاع غزة، والتي تم بناؤها على أساس خطة أخرى طرحها الجنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي، جيورا آيلاند، الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ثم صار باحثًا مشاركًا أول في معهد دراسات الأمن القومي. وصديق شخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

خطة جيورا آيلاند التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023م، بعد عملية “طوفان الأقصى” تتضمن نقل سكان في قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مخيمات في شبه جزيرة سيناء ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني، من خلال اقتطاع 600 كيلومتر من أراضي سيناء لتوسيع قطاع غزة بحوالي ثلاثة أضعاف مساحته.
ونشير هنا إلى أن خطة “حماس” التي تم تقديمها إلى الحكومة المصرية وقت مرسي، كانت تتضمن اقتطاع ألف كيلومتر، على نفس المناطق تقريبًا.
إلا أن الرفض المصري القاطع لهذه الأفكار، دفعت الإسرائيليين إلى تعديل خططهم هذه، إلى ما عُرِفَ بـ”خطة الجنرالات”.
ووفق ما تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، فإنه وفق هذه الخطة تقوم إسرائيل بفرض سيطرتها العسكرية والأمنية على شمال قطاع غزة، وتهجير سكان المنطقة إلى جنوب القطاع، ثم فرض حصار كامل على الشمال، بما في ذلك منع دخول الإمدادات والمساعدات الغذائية والماء والوقود، واستخدام التجويع كوسيلة ضغط لتهجير الفلسطينيين من هذه المناطق.
وبعد تهجير كامل سكان شمال القطاع، يتم تحويل هذه المنطقة إلى “منطقة عسكرية مغلقة” بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة “حماس” في المنطقة، أو انطلاق أية عمليات مسلحة منها ضد مستوطنات غلاف غزة المجاورة.
وتم بالفعل تخصيص طريق “الرشيد مرورًا بمحور “نيتساريم” الذي يقسم القطاع نصفَيْن، من أجل إخلاء المنطقة من السكان، وبالفعل؛ محور “نيتساريم” بالكامل الآن تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتم تسوية المباني عليه بالأرض من أجل تسهيل بقاء القوات الإسرائيلية فيه.
وجزء من أهداف إسرائيل من ذلك، دفع سكان المناطق الأخرى للانتفاض ضد حركة “حماس”، وتقويض سيطرتها على القطاع.
في نوفمبر 2023م، أعلن جيش الاحتلال أن 95 % من سكان الشمال نزحوا إلى جنوب القطاع، بينما ظل هناك ما بين ثلاثمائة ألف إلى أربعمائة ألف فلسطيني، لم يغادروا شمال القطاع حتى بعد عام من الحرب.
وفي مارس 2024م، أعلنت منظمة “ناتشالا” أو “الوطن”، الاستيطانية المتطرفة عن خطط لتوطين 500 عائلة إسرائيلية في غزة مجددًا، منها عدد كبير من المستوطنين الذين أجلاهم الجيش الإسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة في العام 2005م، وكان عددها 21 مستوطنة تضم تسعة آلاف مستوطن يهودي، تنفيذًا لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها أرييل شارون، بإنهاء الوجود العسكري والاستيطاني الإسرائيلي في القطاع.
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، عقد عدد من السياسيين ورموز من اليمين الإسرائيلي المتطرف، مؤتمرًا صحفيًّا بعنوان “الاستعداد لإعادة استيطان غزة”، في منطقة من مستوطنة “بئيري”، الواقعة على الحدود مع غزة، نظمه حزب “الليكود”، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزراء ونواب ونشطاء من أحزاب يمينية أخرى، ومنهم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، ويتسحاق جولدكنوبف وزير الإسكان، وإيتمار بن جفير وزير الأمن القومي، وميكي زوهر وزير الرياضة.
هذه الإجراءات الإسرائيلية كلها، كانت سوف يتم تنفيذها على أرض مصر، لولا عناية الله تعالى، ولولا المواقف الصلبة للقيادات العسكرية والسياسية للبلاد.